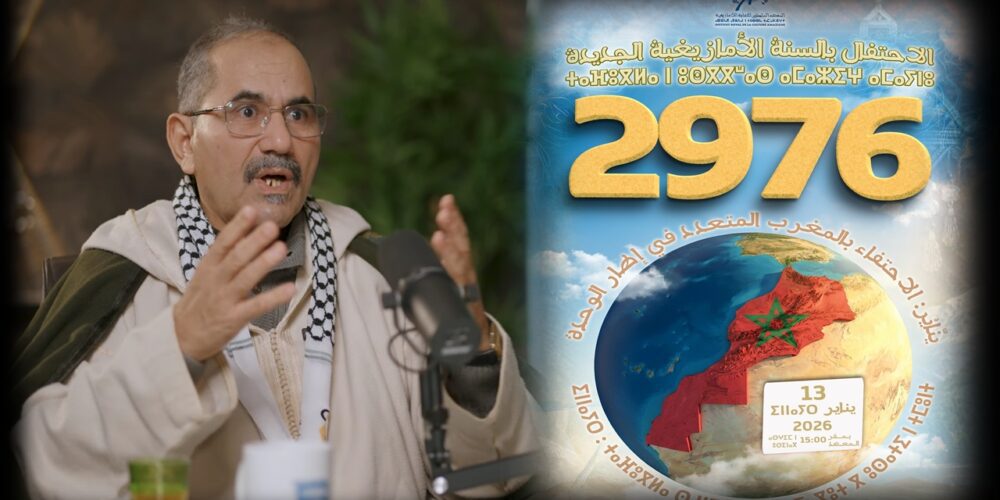العلمانيون والكذب المباح


منير المرود
هوية بريس – الإثنين 27 يناير 2014م
إن أهم ما يميز الساحة الإعلامية المقروءة والمكتوبة والمسموعة هو تلك الحرب الضروس التي يشنها العلمانيون على الإسلام والمسلمين، وبما أن دين العلمانيين وملتهم واحدة فإنهم يستعملون نفس الأساليب والطرق لبلوغ هدفهم الأسمى والمتمثل في شيطنة عدوهم الوحيد والأوحد والمتمثل في الإسلام.
ولئن كان تاريخ العلمانية حافلا بالكذب وتغيير المفاهيم وكيل التهم للمخالف كما هو الحال بالنسبة لسلفهم من المستعمرين الذين نهبوا خيرات الدول المستعمرة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تخوين الحركات المقاومة والمناهضة لخططها التوسعية بالتشويه تارة واستعمال الكذب والبهتان تارة أخرى، فإن إخوانهم وورثتهم ممن نشؤوا وترعرعوا بين ظهراني المسلمين وشربوا من معين المستعمر يستعملون نفس الألاعيب والخطط من أجل القضاء على كل الحركات التحررية التي تهدف إلى الانعتاق من ربقة الاستعمار الفكري الذي مورس على المسلمين عبر عشرات السنين.
وتبقى أبرز وسيلة للضغط على العقل المسلم وغسله هي الكذب الممنهج والمدروس، خاصة إذا علمنا أنهم قد تحكموا في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، فأصبحت صناعة النجوم والمشاهير حرفتهم، فكلما نبغ منهم نابغ قدم للناس على أنه المفكر النحرير والمقاوم الباسل الذي يدافع عن قضايا الفقراء والمستضعفين، وينافح عن الدين من المتشددين والمتطرفين، مستعملين أسلوبهم الشهير في الكذب والتزوير.
إن هذا الأسلوب الذي يعتمده هؤلاء القوم له نماذج وأمثلة كثيرة، من بينها تلك الطلعات التي يطلع بها علينا بعض رموزهم بين الفينة والأخرى لكي يروي قصصا وروايات هي من نسج خياله وبنات أفكاره، يكون الهدف منها زعزعة ثقة الناس بالدين والمتدينين، ومن أمثلته المشهورة التي لا يجب أن تنسى ما نشرته ولا زالت تنشره جريدة الصباح من الأكاذيب والأباطيل التي لا سند ولا مرجع لها إلا التزوير المدروس، عبر مجموعة من المقالات المتهافتة نضرب على سبيل المثال لا الحصر: ما نشرته في العاشر والحادي عشر من مارس 2011 “أن سلفيين اعتدوا على فتاة ونزعوا ثيابها”، وفي 19 أكتوبر 2012: “سلفيون يدمرون مآثر تاريخية بالأطلس الكبير”، وفي 26 نوفنبر 2012: “المعتقلون الإسلاميون احتجزوا موظفا في زنزانة ورفضوا التفاوض مع المسؤولين”، ومقال آخر كاذب بعنوان: “ستة سلفيين يذبحون بائعا متجولا بطنجة” وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 20012، و”سلفي يهاجم زبناء مقهى بطنجة” (19 أبريل 2011)، و”سلفية تخون زوجها السلفي مع سلفي آخر” (9 يونيو 2011)، وآخران حاولا شنق عرافة بسلا (19 أكتوبر 2012)..، وغيرها من الكذبات التي تطير بها ألسنة الناس وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم، قبل أن يتبين بعد ذلك أنها كذب في كذب في كذب.
ومن النماذج أيضا على الكذب الظاهر ما تفضل به مؤخرا داعيتهم المحبوب أحمد عصيد حينما اتهم المغاربة بالتجسس لصالح مصالح الأمن في رمضان في إشارة إلى الاضطهاد -في زعمه- الذي يتعرض له المفطرون والملحدون اللادينيون في رمضان بالمغرب، مع العلم أننا نعلم جميعا كمغاربة أن هذا الأمر هو من نسج خياله كما هي عادته، إذا لا أثر له في واقعنا المعيش، فلم يسبق أن ألقت السلطات القبض على واحد من مفطري رمضان إلا إذا كان ذلك من قبيل تصفية الحسابات لا غير، أما الواقع فهو خلاف ما ادعاه، إذ كيف تستقيم هذه التهمة والكثير من المقاهي أصبحت تفتح أبوابها في وضح النهار بحجة أن خدمتها موجهة إلى السياح الأجانب، في حين أننا نجد الكثير من المغاربة يتناولون إفطارهم علنا دون رقيب ولا حسيب.
وفي نموذج آخر من نماذج الكذب الصراح ما كتبته إحداهن في مقال لها بعنوان: “الإلحاد: أو حكايات مغربيات رفضن قيود المجتمع والدين”، حيث صورت المجتمع المغربي على أنه جماعة متمردة رفضت الدين لما فيه من تناقضات!!! –زعمت- تتعارض مع العقل وما توصل إليه العلم الحديث، ونسبت ذلك إلى “الكثير من الشباب المغربي الذي يعتبر الدين مجموعة من الخرافات والأساطير التي لا يقبلها عقل سليم” -كما قالت-، فنسجت الكثير من القصص والحوارات بين شخصيات وهمية لا وجود لها في الواقع -وإن كنا لا ننكر وجود الإلحاد والملحدين بالمغرب-، كلهن متفوقات في الدراسة -في إشارة خفية إلى أن غيرهن ممن التزمن تعاليم الإسلام لسن كذلك-، كما أنهن توصلن إلى الإلحاد عن قناعة بعد أن درسن الدين الإسلامي وغيره من الأديان، وبما أن مثل هذه المقالات التي يصلح أن تكون نموذجا للقصة القصيرة تنبني على الكذب والافتراء فإنها تحمل بين سطورها ما يدل على تخبطها وتناقضها، إذ أن كاتبتها -أي القصة- تزعم في أول المقال أن هذا حال الكثير من الشباب المغربي ثم تناقض نفسها بنفسها بعد ذلك بأسطر قليلة حينما نسبت إلى أحد الباحثين قوله: “إن الدراسات الميدانية حول القيم تظهر أن الشباب المغربي عموما، تتصاعد وتيرة تشبعه بالقيم الدينية مقارنة بالقيم ذات المرجعيات الحقوقية أو (الأنوارية) أو العلمانية” فكيف يوصف أكثر الشباب المغربي بوصفين متناقضين أحدهما رفض الدين والآخر التشبع بقيمه.
كما أن الرغبة في تحسينها للنص واستعمال الأسلوب التصويري جعلها ترتكب خطأ فادحا يدل على عدم المصداقية في الحوارات المذكورة، ولنتأمل هذه السطور جيدا لندرك مدى فظاعة الجرائم التي يقوم بها هؤلاء باسم حرية التعبير، حيث تقول على لسان إحدى الملحدات: “أجبرني والدي على ارتداء الحجاب وعمري عشر سنوات، لم أستطع أن أقاوم، في البداية، لصغر سني. وكان يمنعني من أن أخرج لألعب الكرة مع أصدقائي، بينما يسمح لأخي بذلك”؛ بحزن ممزوج بالتحدي تحكي سناء، خريجة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة عن أسباب إلحادها، مضيفة وقد أطرقت رأسها المغطى بالحجاب”، فيا ليت شعري كيف يجتمع الحجاب والإلحاد في صورة واحدة ومشهد واحد.
إنني في هذا الصدد لا أنكر وجود الإلحاد والملحدين في المغرب كيف ذلك وقد عايشناهم وناقشناهم وحاورناهم في الجامعات وأروقة المنتديات، إنما الغرض من هذا العرض هو بيان عدم المصداقية الظاهرة عند القوم والتي تبدو واضحة جلية من خلال ما تدونه أقلامهم وتسطره أيديهم من كذب صريح امتثالا لقول ذلك الإعلامي الشهير حينما أراد وصف الإعلام المضلل بقوله: “اكذب ثم اكذب ثم اكذب..”.
هكذا يريد هؤلاء تصوير المغاربة، حيث يعملون على تكوين صورة مشوهة لهذا المجتمع الذي لا يزال يتمسك بدينه وقيمه رغم الهجمات التغريبية التي يتعرض لها عبر عقود من الزمن، فالذي لا يعيش في المغرب إذا اطلع على هذه المقالات ستتكون لديه صورة نمطية عن المغاربة والمتدينين بشكل أساس، فهم يقتلون ويعتدون ويضربون ويشنقون ويقطعون الأيدي والأرجل ويخونون ويدمرون ويشون ويتجسسون وينهبون وللنساء ظالمون.. فيا للعجب أين يعيش هؤلاء الذين يفترون كل هذه الافتراءات ؟ ولحساب من يعملون؟ ولماذا تتفق مناهجهم وطرقهم في التزوير والتشويه رغم اختلاف أقطارهم وجنسياتهم؟ ألا يدل ذلك على أنهم ينهلون من معين واحد..
elmaroud@gmail.com