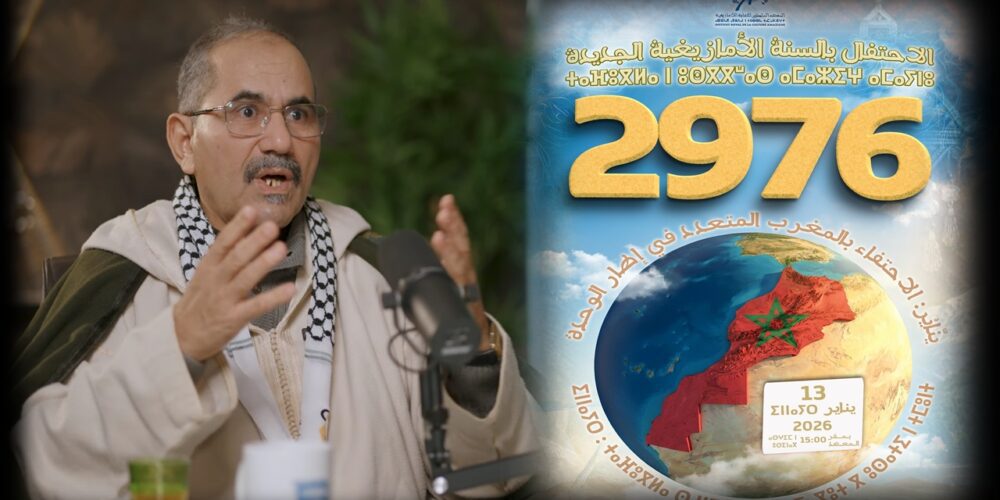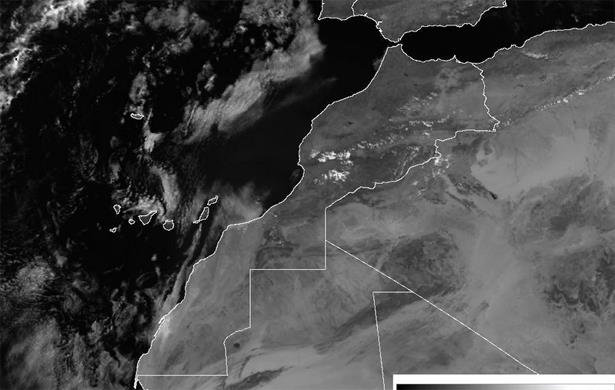مقتل الأستاذ عبد الله بَها بين التشكيك والتحقيق والتحليل


محمد أقـديـم
هوية بريس – الجمعة 12 دجنبر 2014
تعتبر حادثة مقتل الأستاذ عبد الله بها، رحمه الله (نقول مَقْتَل سواء قتله القطار أو غيره)، تعتبر هذه الفاجعة، بما للمرحوم من وزن سياسي كبير على المستوى الوطني، ومن مكانة كبيرة في المشهد السياسي الوطني، سواء كفاعل سياسي، أو كقائد دعوي، أو كمسؤول حكومي، وبحكم الظروف والسياق والمكان الذي وقعت فيه، تعتبر لغزا مُحَيِّرا للجميع، وبالتالي من الطبيعي جدّا أن تطرح الكثير من التساؤلات وأن تثير العديد من الشكوك، وأن تخضع لمختلف التحليلات، وأن تختلف مسارات مقاربة هذه الحادثة المُفْجِعَة.
وهذا يفرض ضرورة انجاز تحقيق نزيه وموضوعي من طرف الأجهزة المختصّة حولها، حتى تتطابق نتائج التحقيقات الأمنية مع خُلاصات التحليلات السياسية العلمية، وتزيل كلّ الشّكوك المثارة.
والذي يجب أن يعرفه الكثيرون ويستوعبوه جيّدا، هو أنّ المحللّ السياسي أو صحافة التحقيق المهنية لا ينتظران بالضرورة إعلان نتائج تحريّات المحقّق الأمني، حول أي حادثة أمنية ذات أبعاد سياسية، لكي يقوما بعد ذلك وبناء عليها بإنجاز مهمتهما المعرفية والإعلامية بالتحليل العلمي لسياق الحادثة وانعكاساتها السياسية ونتائجها المرتقبة، وبنشر المعلومة الصحيحة حول تلك الحادثة. ومن الممكن أن تتناقض خلاصات التحقيق الصحافي والتحليل السياسي مع نتائج التحقيق الأمني، مهما كانت نزاهة هذا الأخير واستقلاليته.
وبالتّالي فمن يقدّم تحليلا سياسيا منطقيا بناء على وقائع صحيحة وملموسة، تجمع بينها خيوط واضحة، ويخرج بخلاصات منطقية، ويضع سيناريوهات محتملةُ الوقوعِ حول هذه الحادثة المُؤلِمة قد تخالف الرواية الرسمية أو مواقف بعض الأطراف السياسية، لا يمكن أن نعته بسوء النيّة أو أنّه يرجم بالغيب، أو أنّه يخوض في دماء زكية، أو أنّه من أنصار نظرية المؤامرة، فكفى وصاية على عقول النّاس، وكفى حجرا على حرية التّحليل والرأي.
الشكّ والتّشكيك
من المعلوم أن التحقيقات الأمنية حول جميع الحوادث تنطلق دائما في مبدأ الشكّ وعليه تقوم ببناء فرضياتها ومنها تنطلق لرسم الاتجاهات المتعدّدة التي تسير فيها العمليات التقنية للتحقيق.
الشكّ عملية عقلية مرتبطة بعملية التفكير التي تعتبر جزءا منها، وبما أن العقل لا يمكنه بتاتا، أن يستشير صاحبه في التفكير، ولا يمكن أن يأخذ منه الإذن للممارسة عملية الشك في أمر ما، وحيث جعلت المواثيق الدولية والدساتير الوطنية من التفكير (والتشكيك جزء منه) حق من حقوق الإنسان، فالشك والتشكيك بدوره حق من الحقوق التي يجب صيانتها والدفاع عنها، خاصة في ظل أنظمة سياسية مغلقة ميزتها الأساسية الاستبداد بالمعلومة واحتكارها كجزء أساسي من الاستبداد بالسلطة والثروة، وبالتّالي تمارس التّعتيم والتّمويه عن الرأي العام، بل وتمنع وتصادر كل ما من شأن أن يطعن في ما تقدّمه هي من معلومات، لتصادر بذلك حق الشك التشكيك والارتياب في روايتها للأخبار والوقائع، التي تراها مقدسة، لا يجب المساس بها.
كما أن الشك كذلك أداة منهجية تقود إلى نسبية الحقيقة العلمية والمعرفة البشرية، التي تجعل سُلوكات الإنسان وأقواله تحتمل الخطأ والصواب، مؤسسة بذلك للقاعدة الأساسية لكل فكر ديمقراطي، والمتمثلة في الإيمان بالاختلاف، وعدم امتلاك الإنسان الفرد للحقيقة المطلقة. ومن هذا المنطلق يمكن فهم العداء الشديد للأنظمة الاستبدادية القمعية لكل من يشك في ممارساتها وخطاباتها. والشك بما يعنيه، إعلاميا وسياسيا واجتماعيا، من فقدان للثقة والمصداقية في المسؤولين وسلوكاتهم وتصريحاتهم، لم يأتي عبثا أو أمطرت به السماء صدفة، وإنما كان نتيجة تراكمات كبيرة للممارسات والخطابات، وبشكل مستمر ومتواتر، ممارسات وخطابات المسؤولين التي تفتقد لأبسط شروط الأمانة والصدق.
ومشكلة المسؤولين بالمغرب هي أنهم مازالوا يتعاملون مع المواطنين المغاربة وكأنهم لا يملكون أية مصادر للمعلومات حول قضايا المغرب، إلا ما يتفضلون به، وما يصرحون به في بياناتهم أو ما تقدمه وسائلنا الإعلامية العمومية (وكالة المغرب العربي للأنباء – قنوات تلفزية وإذاعية..) وبالتالي يظنون أنه من السهولة التمويه والتعتيم على المواطنين، في وقت لم يعد المغاربة يلتفتون فيه لهذه المصادر بالمطلق، لشكهم الكبير في مصداقيتها، ولوفرة المعلومة حول المغرب من مصادر كثيرة ومتنوعة (قنوات فضائية وإذاعية أجنبية + الانترنيت + المواقع الاجتماعية..) بمعنى أن لا تأثير لتصريحات المسؤولين المغاربة ووسائل إعلامنا العمومي في تشكيل الرأي العام بالمغرب، لعدم الثقة فيها، وعدم مصداقيتها وعدم استقلاليتها وعدم نزاهتها.
التحقيق والتحليل
هذه الفاجعة تطرحُ العديد من التساؤلات، التي تقود بالضرورة الى اختلاف الخلاصات، التي من الممكن أن يستنتجها كل باحث متتبع للأحداث والوقائع بالمغرب، ومن ثمة اختلاف المواقف المبنية على تلك الخلاصات. فإذا كانت كلّ حادثة أو كلّ فعل إجرامي أو عمل إرهابي لابد له من منفذين ومخططين ومستفيدين، وبما أن عمل المحققين الأمنيين ينطلق من الحادثة في حد ذاتها وأدوات تنفيذها (العناصر المادية للحادثة أو الجريمة)، سواء من خلال تحديد طبيعة الوسائل التقنية والمواد المستعملة فيها، وتركّز على مكان الحادثة، وجميع الحيثيات الأمنية والمادية للحادثة، من أجل الوصول أولا إلى مُرْتَكِب الحادثة (إن كان هناك فاعل)، وعن طريقه يمكن الوصول مثلا إلى المخططين (إن كان هناك مُخَطِط للحادثة أو الجريمة)، وأخيرا تحديد المستفيدين منها، فإن عمل الباحث والمحلّل السياسي ينطلق في اتجاه معاكس لاتجاه المحقق الأمني، حيث ينطلق من السّياقات السياسية والاجتماعية، الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تحديد المستفيدين المحتملين من الحادثة أولا، من أطراف سياسية وطنية وتكتلات اقتصادية، وجهات خارجية، كما يسعى إلى معرفة المتضررين من الحادث، سواء كانوا أطراف سياسية أو اقتصادية، ليطرح الأسئلة حول المواقع المُفْترَضَة للمخططين للحادثة، فيتساءل عن هويّة المُنفِّذين المحتملين لها، ثم يضع لذلك العديد من الافتراضات. ويكون تركيزه على الجهات المستفيدة من الحادثة أكثر من التركيز على المُنفذين ووسائل التنفيذ، لذلك يعمل على وضع الحادثة في السياقات الزمنية والسياسية والاجتماعية والدولية، فيقوم ببناء فرضياته المختلفة ويضع سيناريوهاته المتنوعة، ولذلك تكون خلاصات الباحث والمحلّل السياسي، أو حتّى المواطن العادي حول الحادثة أو الجريمة متقاطعة مع نتائج عمل الأجهزة الأمنية، بل من المحتمل أن تتناقض استنتاجات المحلّل السياسي مع نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية، وهذا ما لا يروق المسؤولين السياسيين والأجهزة الأمنية، وخاصة في البلدان غير الديمقراطية، إذ غالبا ما يتم اللجوء إلى تكميم الأفواه، وتكسير الأقلام التي تفتح عليهم الباب للشكوك والظنون.
وموت الأستاذ عبد الله بها، رحمه الله، كشخصية عامّة، لا يعني أسرته الصغيرة ولا أسرته السياسية الكبيرة وحدهما، بل يهمّ الشعب المغربي برمّته باعتبار مسؤولا حكوميا وفاعلا في تدبير الشأن العام، وبالتالي فسكوت أسرته الصغيرة أو الكبيرة لا يُلزم ولا يمنع الرأي العام المغربي ومختلف مكونات المجتمع المدني والصحافة والفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية من متابعة الملف والحفر فيه بالتحليل والدراسة والمتابعة والتحقيق، لأن المرحوم، كفاعل سياسي ودعوي، ليس ملكا لأسرته أو حزبه فقط، بل مِلْكُ للمغاربة قاطبة. ولا داعي للتسرّع في هذه اللحظة، فالجميع لازال تحت هول الصدمة، وقد تتغيّر المواقف والآراء بعد ما تهدأ الخواطر، وقد تظهر معطيات جديدة يمكن أن تقلب كل الحسابات والتقديرات، وإذا كان لقيادة حزب البيجيدي تقدير معيّن للمرحلة واعتبار لمصلحة معيّنة، ترى أنّه لا ينبغي عدم التفريط فيها، أو لمفسدة كبرى يجب تفويتها في الظرف الراهن، ولعدم توفُّرها على المعطيات الكافية لاتخاذ موقف واضح، لذلك لجأت الى السكوت، فلا ينبغي أن تُرْتَهَنَ أراء الباحثين والمحلّلين السياسيين ومواقف الحقوقيين ومهمّة صحافة التحقيق في البحث عن الحقيقة في هذه الفاجعة، بموقف قيادة حزب البيجيدي وأسرة بها الصغيرة.