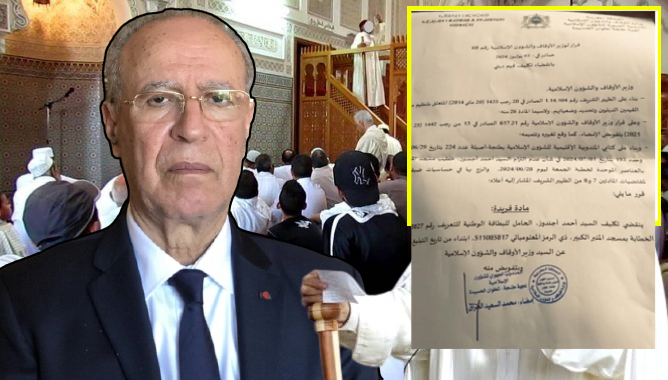من ثمرات تدبر القرآن


د. عبد الله الشارف
هوية بريس – الأحد 24 ماي 2015
إن مما لا يخفى على المؤمن اللبيب أن تدبر القرآن والتفكر فيه وإعمال العقل في آياته، واستنباط الحقائق واستخراج الفوائد منها، كل ذلك مما أشارت إليه كثير من الآيات الحكيمة. ولولا الإكثار من التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، ما كتب العلماء والفقهاء قديما وحديثا أصنافا من العلوم والمعارف، ولما اهتدوا إلى مجموعة من الحقائق الصحيحة والنافعة.
قال تعالى: “كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب” (ص:29).
وقال أيضا: “أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا” (النساء:82). وقال تعالى: “أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها” (محمد:24).
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التدبر والتأمل وإعمال العقل والفهم. وقراءة القرآن بلا تدبر كممارسة العبادة بلا فقه ولا خشوع. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي: “إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم” (المائدة:120)1.
وترديد الآيات أثناء القراءة أو في صلاة الليل، له أثر عميق في النفس لكونه يفضي بصاحبه إلى التدبر والتأمل فتتحرر نفسه من قفصها، وتنجذب إلى عوالم الآخرة والسكينة.
كما أن تدبر القرآن يبعث على تأمل وفهم دلالة الآيات على المقاصد التي يسترشد المسلمون بها، واستنباط المعاني واستخلاص العبر، وفي ذلك خير عظيم يجلبه لنفسه القارئ المتدبر والمتفهم لآيات الله. ولقد كان ذلك دأب السلف الصالح ومنهجهم في التعامل مع القرآن الذي انفعلت به نفوسهم، وتأثرت به قلوبهم، فظهر أثر ذلك على جوانحهم وفي أعمالهم الجليلة.
ويطلق التدبر في اللغة العربية على النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه. وتدبر الكلام يعني النظر في أوله وآخره مع إعادة النظر بهدف التيقن. وإن مما يدعو للعجب أن تجد كثيرا من المسلمين يقرأون القرآن ولا يجنون ثمرة قراءتهم، لخلوها من الخشوع والتدبر والتفكر. فلا سبيل لنور القرآن إلى قلوبهم لكونها مقفلة ومغلقة بسبب الانشغال بالدنيا وحظوظ النفس.
نعم، إن قارئ القرآن بتدبر وخشوع وإخلاص، لهو أهل لأن يظفر بمحبة الله والشوق إلى لقائه، والخوف من عذابه، والتوكل عليه، والشكر على نعمه، والصبر على بلائه. وبما أن تدبر المؤمن للقرآن والخشوع في تلاوته دليل محبته لله وتعظيمه لكلامه، فإن تلك المحبة الصادقة هي التي أورثته أحوال الشوق والخوف والشكر والرضا والتوكل.. وهذا من ثمرات التدبر الناتج عن المحبة. ولا يسعني، في هذا الصدد، إلا أن أسوق كلاما لابن القيم رحمه الله، جمع فيه من ثمرات تدبر القرآن ما يثلج الصدر ويحيي القلب:
“فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته، وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه.
وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.
فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها، ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. فتريه الحق حقا، والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة، وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر”2.
إن هذه الثمرات العظيمة التي أشار إليها فقيهنا الجليل محمد بن قيم الجوزية، لهي من جوامع كلمه ولآلئ فوائده المبثوثة على صفحات كتبه القيمة. وإني أنصح طلبة العلم بالإكثار من قراءة مؤلفات ورسائل هذا العالم المتبحر الفذ، فقد كان في حياته صادقا مع الله متبعا سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأفنى عمره في نشر العلوم المفيدة.
وقال أيضا: “وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى: “والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر”، أقسم سبحانه أن كل واحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما، والتواصي بهما، كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة، والأذواق والمواجيد الصحيحة، كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته”3.
ما أنفس كلام العلامة الفقيه محمد بن قيم الجوزية، وما أحوجنا إلى الاستفادة منه وممارسته في حياتنا. ومن ناحية أخرى فإن إدراك الطبيعة العلوية للخطاب القرآني واستشعار الحق الكامن فيه، يتطلب تجريد النفس من أهوائها والإنصات إلى معانيه بقلوب منفتحة صادقة. والأسباب المساعدة على ذلك كثيرة، سأذكر منها سببين:
أولا: حضور القلب أثناء التلاوة، وهو أس هذا البناء وشرطه اللازم، إذ كيف يتصور جني ثمار التلاوة والقلب ساه أو غافل. قال تعالى: “إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” (سورة ق:37).
ولكي يتم للعبد حضور القلب أثناء التلاوة، ينبغي لقارئ القرآن أن يجمع همته ويركزها في القصد المطلوب. وهذا أمر منطقي ومجرب؛ فإن الذي عقد العزم على إتيان أمر ما، أو القيام بمهمة معينة واستفرغ لذلك وسعه وبذل فيه جهده، لا بد أن يحصل له من التركيز فيما هو مشغول به والانصراف عن كل ما يشوش عليه عمله. وعلى قدر محبته وتعظيمه لذلك الأمر ماديا كان أو معنويا، يتحرر باطنه من الوساوس والأفكار المثبطة وصنوف من أحاديث النفس الجالبة للكسل والوهن، والمسببة في الإعراض عن القيام بجلائل الأعمال. وإذا كان التركيز وجمع الهمة في أمر دنيوي ابتغاء تحقيقه ونيله، يفضي في غالب الأحيان إلى الغرض المقصود، فمن باب أولى أن يؤدي هذا الشرط إلى الغرض المرجو إذا تعلق الأمر بقراءة القرآن.
وغني عن البيان أن الذي يقبل على قراءة الذكر الحكيم بشغف وهمة ووقار، مع تعظيم الله وإخلاص الدين له، وصدق لهجة المناجاة من خلال الترتيل، يجد من اللذة الروحية ما يعجز عن وصفه الواصفون.
ثانيا: الخشوع، حيث أن حضور القلب ينتج عنه الخشوع، وذلك بطريقة تلقائية، فمن حضر قلبه خشع. قال تعالى: “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق”4. وقال أيضا: “الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله“5.
والخشوع يجعل قلب المسلم يذل ويخضع لخالقه، كما تلين جوارحه لطاعته، وبالتالي فإن باطنه يغدو محلا لتنزل الرحمات، وورود الإشراقات والنفحات الإلهية. ثم إن اللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في علم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أشد. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم، يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يخطر على بال غافل ولا يرقى إليه عقل جاهل.
وإذا تعود المؤمن استحضار قلبه والتحلي بحلية الخشوع أثناء تلاوة القرآن، فقد أذن لنفسه بولوج عالم التدبر، ذلك الفضاء المعنوي الفسيح الذي لا يتوقف عن الاتساع بفضل إمدادات حالتي الحضور والخشوع، وترى العبد يسبح في أرجائه ممتطيا معاني الآيات، منتهلا من حروف “إقرأ”؛ “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”. تارة تعتريه الدهشة والحيرة من شدة الأنوار الساطعة من أصل تلك الحروف وما تحمله من إيحاءات ربانية متلألئة، وتارة أخرى ينجذب إلى صلصاله الطيني حتى لا يزيغ عن دورته الفلكية، أو يحمله هيمانه إلى عالم قد يكون فيه حتفه كما حصل لأصحاب الحلول ووحدة الوجود من الصوفية، وحتى يعرف أن التحقق بالعبودية الحقة يستلزم القيام بواجبات الاستخلاف وتطبيق شريعة الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح.
[2] مدارج السالكين ج1/ص:363.
[3] مدارج السالكين ج1/ص:28-29.
[4] سورة الحديد آية:15.
[5] سورة الزمر آية:23.