لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة

هوية بريس – حسن المرابطي
اِعلم أن الإنسان مهما تقدم وبلغ من المراتب العلى في العلم والتكنولوجيا، يبقى دائما ضعيفا، بل يدرك، كل مرة، أنه لا يستطيع تجاوز الإشكالات الكبرى، وربما حتى الصغرى، دون تدخل الله، أو تدخل الطبيعة عند من يجحد وجود الله؛ والجحود في أصله استيقان بتدخل الإله ولكن ظلم وعلو الجاحد يجعل من عاقبته عبرة لكل عاقل، ولعل تدبر قول الله عز وجل يدلنا على حقيقة الإنسان الجاحد بما لا يدع مجالا للشك، قال عز وجل: “وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ“.
عليه، فإن ضعف الإنسان واستمراره في العناد والكبر، يورده المهالك في كل مرة، بل نهايته ستكون مأساوية بكل ما تحمل من معنى، قال تعالى في كتابه الكريم: “وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ“، حتى أمست القضية الأجدر بالبحث والدراسة هي نفسية هذا الإنسان العنيد وهو يعرف قيمة نفسه، رغم ذلك لا يستحي من خالقه عندما يكرمه ويرزقه بمختلف النعم، ولعل نعمة العلم يتجاهلها الكثير لما ترسخ في الأذهان أنها نتيجة اجتهاد ومثابرة، وليست رزقا من الله وأمرها لا يختلف عن باقي النعم الأخرى.
وبما أن حالة المستيقن بقدرة الله والجاحد في الظاهر، لا تنصرف إلا على كبار طغاة الأرض، ولعل أكبر زعيم لهم هو فرعون اللعين والذي حدثنا عنه القرآن الكريم، فإنه لا يُستبعد اللحاق بدرجة هؤلاء وتجاوز مستويات الاستعلاء والجحود التي بلغوها، لاسيما أن فعل الجحود لا يقتضي بالضرورة الاقتران بمظاهر القوة والسلطة، كالتي أهلكت فرعون، بل تختلف مظاهرها، فقد تتخذ من السلطة والتسلط مظهرا، وقد تأتي في مظهر آخر، هو مظهر العلم والمال، ولا يقل تأثيرا عن سابقه، بل ينبهر المرء من شدة تزيين الشيطان له وايهامه بقوته وقدرته على التحكم في الكون، حتى أمسى ورثة قارون يرددون كلماته ولو لم يسبق لهم اللقاء به، قال تعالى: “قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي“، فما أشبه اليوم بالأمس، عندما ينسى المرء ربه ويتبع خطوات الشيطان.
إن التأمل فيما سبق، يفرض علينا الانتباه إلى حال قلوبنا، التي تخضع بعض الأحيان لأوامر الشيطان ونحن في غفلة من أمرنا، فضلا عن التحري والتدقيق في الكلمات التي نرددها دون التفطن إلى ما تحمل من معاني في غاية الخطورة، مقلدين بذلك من تبين ضلال نهجه، لما أتاه من الأفعال التي تلّقى بشأنها أوامر من الشيطان، قال تعالى: “وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا“، ولعل أصدق مظهر في التشبه بحال من اعتقد قوة علمه وقدرته على تغيير خلق الله، إعلان الانتصار في الحرب على كثير من الأمراض، التي نبتلى بها، بل الاعتقاد الجازم واليقين الذي لا يتزعزع في قدرتهم التحكم في مخلوقات الله، حتى صار المنبهر، ببعض مظاهر اتباع خطوات الشيطان، لا يستبعد قدرة الإنسان، بعدما بلغ من العلم ما بلغ، التحكم في الخلق تغييرا وتبديلا، لدرجة تمني ومباشرة البحث للقضاء على الموت والأمراض بمختلف أصنافها.
بعد الوهم الذي تفشى في صفوف المستكبرين وأتباعهم، تبين بعد جائحة كورونا 2019، أن الإنسان لم يبلغ تلك الدرجة التي اعتقد، بل على العكس تماما، تأكد لديه أن الإنسان المعاصر في غاية التوحش، لما أظهره من حب التسلط على غيره ومتاجرته بمآسي الناس، حتى بلغ به الأمر الاستمتاع بضعف أخيه الإنسان، ذلك بوهمه كل مرة بامتلاك مفاتيح كل شيء رغم يقينه بعكس ذلك، مما جعل خطر الأمراض والفيروسات أهون بكثير من الإنسان المعاصر المتوحش الفاقد للأخلاق، بعدما تبين أن الوباء مهما تسبب في الأزمات، فهو راحل بعد حين بإذن الله، لكن جشع وتسلط الإنسان لا حدود له ولا رادع لظلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وفي هذه الظروف، ونحن نتأمل واقعنا بحكم اعتناقنا الدين المنزل من الله عز وجل، ودرجة تأثيرنا وتأثرنا بالواقع المر، ندرك قيمة الدين الذي وجب علينا اتباعه وتبليغه لما فيه من التعليمات القادرة على تجاوز كل المحن التي تمر بالعالم، بيد أن واقعنا، للأسف، أمسى جزء من واقع العالم المتوحش، حتى ظن بعض أبناء جلدتنا من شدة جهلهم بدينهم أن مآسي العالم نتيجة تشبثنا بالدين، متناسين أن انحطاط المسلمين كان نتيجة ضعف تدينهم واعوجاج اعتقاداتهم مما انتهى بهم الأمر إلى أسوأ حال.
وبهذا الأمر، يبقى إعادة النظر في تديننا واجب الوقت، لما تسبب من تخلف، بل تبريره بعض الأحيان، لأن أسمى فعل يمكن الإقدام به والذي حدده ربنا سبحانه وتعالى: “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“، حتى لا ننساه كما حدث معنا، لأن الاعتقاد بصلاح الدين كان منصبا في غالب الأحيان على بعض المظاهر والأشكال، وجعلنا منه منهج حياة بشكل معوج، حيث رجحنا الجانب المادي فيه على الجانب الروحي، لاعتقادنا أولويته، بل غاية الدين، لأن التجاءنا إليه في كل مرة يكون نتيجة تعثرنا في تحقيق مظاهر الحياة السعيدة، وليس من أجل التعبد أصالة وتسخير كل مظاهر الحياة، حلوها ومرها، في تحقيق العبودية لله، حتى صار منا من يتحدث عن أعلى القنوات التي بها نعرج ونعبد الله، وهي الصلاة، بشكل مادي صرف، محاولا إبراز الجوانب الفيزيائية والطبية وغيرها إلا التقرب بها إلى الله عز وجل، حيث أصبح لسان حال الكثيرين: هل من نتائج مادية واضحة لأوامر الله حتى نأتيها، وإلا تركتها إلى حين اكتشاف فاعليتها المادية، هذا إن لم يستهزئ بها والعياذ بالله.
إن جائحة كورونا نبهت الغافل منا بضرورة العودة إلى الله، لكن الإبقاء على نفس الطريقة التي أدت بنا إلى تعميق الأزمة الأخلاقية، لن نخرج منها إلا بالدخول في أزمة أخرى آتية لا محالة، ذلك أن التدين من أجل مكاسب مادية مغلبا الجانب الشكلي، جاعلا منه المقصد والغاية، بعيدا عن تحقيق العبودية، والارتقاء في مراتب الإيمان، متوسلين بكل العلوم ومظاهر القوة التي جعلتنا في بعض الحالات ننسى الله وفضله ولا نذكره إلا قليلا، حتى أصبح الشفاء من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد Covid-19 انتصارا للأطباء وبعض وصفاتهم والأجهزة الحديثة، مما جعل الكل يصفق للمتعافى من المرض والطبيب المداوي تقليدا لمن سبقنا، بدل التضرع لله وشكره على شفاء المريض على يد الطبيب الذي وصف الدواء، حتى نعبد الله حق عبادته ولا نشرك معه أحدا، كل هذا دون الانتقاص من دور الطبيب الذي وجب عليه الاجتهاد في طلب أسباب الشفاء حتى يحسب ممن أحيا الناس جميعا، ولم ينسى فضل ربه أبدا.
اللهم ارزقنا التدين الصحيح وبصرنا بعيوبنا يا من خلق السموات السبع والاراضين.




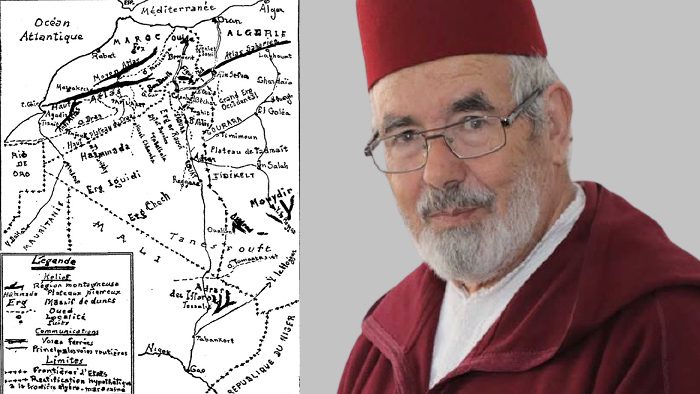
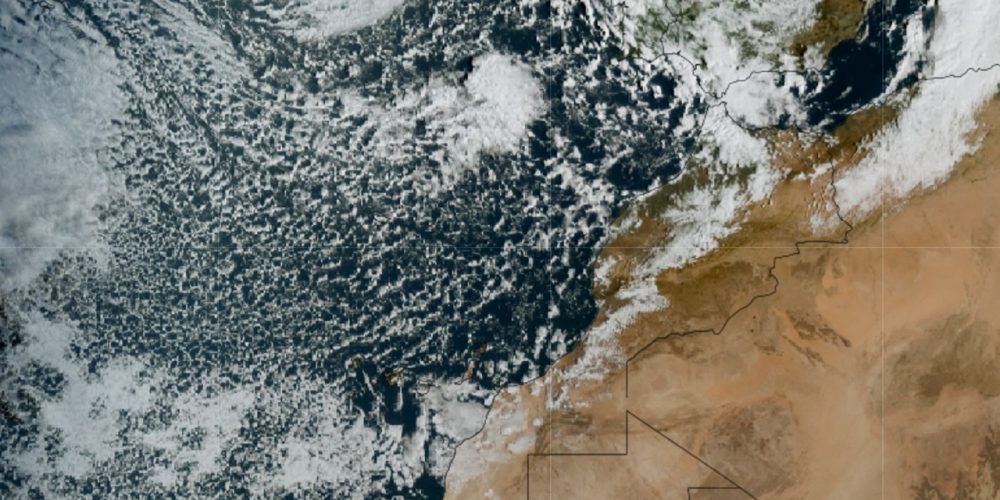



































أحسنت جزاك الله خيرا وبارك فيك.
وضعت يدك على الداء أصلح الله بك.