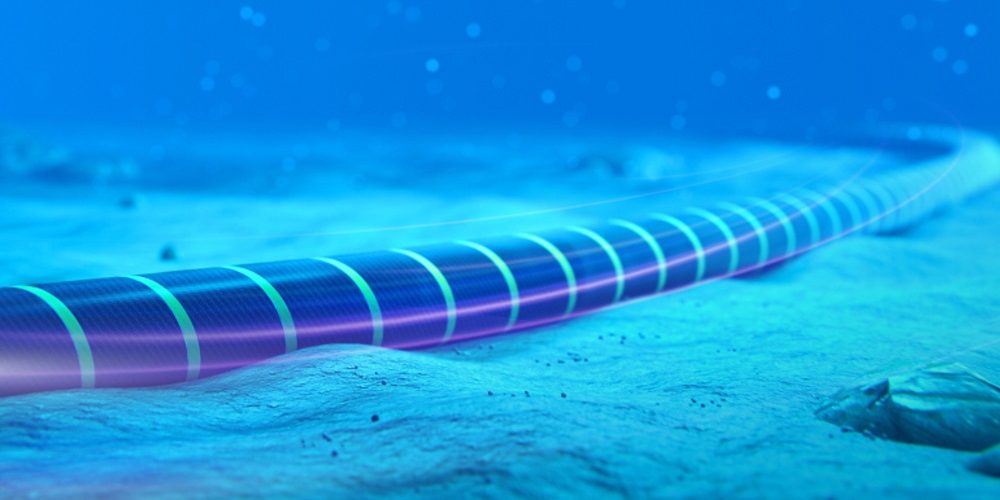التعويذة السحرية

هوية بريس – حليمة الشويكة
كثيرة هي المفاهيم التي تتعرض للاستنزاف الدلالي إلى الحد الذي تفقد معه عمقها الفكري والتاريخي، ويصير استعمالها شبيها بالوصفات السحرية الجاهزة والقادرة على تقديم حلول سريعة وناجعة لأكثر المشاكل صعوبة وتعقيدا. ومن بين هذه المفاهيم التي تعرضت للتضخم اللفظي والانحراف الدلالي مفهوم “النموذج التنموي”، الذي حمله إلى الواجهة السياسية والفكرية والإعلامية سياق خاص انطلق منذ الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية 2017. فمنذ هذه اللحظة أصبح الجميع يتحدث عن عجز النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه ولم يعد قادرا على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا على الحد من الفوارق الفئوية والمجالية التي تزداد اتساعا. وغالبا ما يتم إرجاع هذا العجز إلى فشل كل السياسات المتعاقبة في استهداف الفئات الاجتماعية الفقيرة التي تجد عنتا في الولوج إلى عالم الشغل والتعليم والصحة والخدمات الأساسية. هذا الفشل عكسته بوضوح الحركات الاحتجاجية التي كانت لها مطالب اجتماعية بمختلف المناطق المهمشة بالمغرب.
وما إن تم الإعلان عن ضرورة التفكير في نموذج تنموي جديد يخرج البلاد من حالة العجز ويقدم حلولا للتناقضات الاجتماعية، حتى دخل المفهوم إلى مساحة المصطلحات العائمة التي تفتقد للدقة والوضوح اللازمين، وبدأت عملية صياغة الوصفات التي تقدم “النموذج التنموي” وكأنه تعويذة سحرية بإمكانها أن تخلق المعجزة بمجرد تطبيقها على أرض الواقع. والحال أن العديد من المذكرات التي تناولت مسألة النموذج التنموي -دون تعميم- سقطت في الخلط واللبس بينه وبين المخطط التنموي والبرامج الإصلاحية والملفات المطلبية..
إذا جاز لنا الحديث عن النموذج التنموي فينبغي بداية تمييزه عن كل ما سبق، فالنموذج بنية فكرية مجردة من كل التفاصيل، يتم ترتيب وتنسيق عناصره بحيث تصير له هوية خاصة به تميزه وتمنحه فرادته، على أن تكون العلاقة بين عناصر النموذج والواقع علاقة تماثل، لأن النموذج لغة هو مثال الشيء وأنموذجه الذي يُقتدى به. أما التنمية، التي تتم محاولة نحت نموذج لها وفق التعريف السابق، فهي من المفاهيم ذات الحمولة الدلالية الكثيفة والمتعددة والمتداخلة، لأنها مرتبطة بالنمو الاقتصادي لكنها تتجاوزه لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية. ومهما تعددت دلالاتها، فغايتها تبقى بالأساس هي تحقيق الاستقرار والرفاهية للأفراد وتلبية حاجياتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. وهذا يعني أنه لا يمكن الحديث عن التنمية إلا إذا تم إحداث تغيير في العلاقات الاجتماعية وتنمية العلاقات الإنسانية في حقل اجتماعي معين.
فهل يمكن تصور نموذج تنموي قادر على استحضار هذه الأبعاد التنموية في شموليتها؟ هل يمكن أن يوجد بالفعل نموذج تنموي يكون في الآن ذاته بنية فكرية مجردة، وقادرة أيضا على أن تشمل كل أبعاد الوجود الإنساني داخل بيئة اجتماعية معقدة ومركبة؟
لا يمكن ادعاء القدرة على تقديم جواب حتمي وصارم على إشكال بهذا الحجم، لكن بالإمكان ملامسة جزء من الإجابة عبر البحث عن مدلول ومحتوى مفهوم التنمية بالرجوع إلى سياقها التاريخي، فهذا المفهوم -حسب باسكون- لم يظهر إلا حديثا بعد الحرب العالمية الثانية حيث ارتبطت فكرة التنمية في السياق الأوروبي بالرأسمالية الخاصة للبورجوازية الليبرالية، كما ارتبطت عند الدول المستعمَرة بظاهرة التحرر من الاستعمار. ولكن الجيل الذي حقق الاستقلال كان في نظر باسكون جيلا مستعمَرا مجتمعيا وثقافيا، لأن تكوينه المجتمعي وتجربته الإنسانية تم تشكيلهما في ظل الوضعية الاستعمارية. الشيء الذي أدى في نظره إلى اعتقاد جيل الاستقلال بأن مرحلة ما بعد الاستقلال هي مرحلة بناء المجتمع على صورة المجتمع المستعمِر. وكأن فكرة التقدم التي تنضوي داخلها فكرة التنمية، لا تتم إلى بتدارك “التأخر” الذي يتوهمه البعض بين دول “متقدمة” وأخرى “متخلفة”.
بعيدا عن الإشكالات الدلالية لمفهوم “النموذج التنموي” وعن عمقها التاريخي، ومن أجل المضي في مطارحة الموضوع بلغة تتجاوز الطابع السحري والتضخم اللفظي، يمكن البدء بتشخيص أعطاب “النموذج التنموي” انطلاقا من الاعتقاد المشار إليه سابقا، فعلى الرغم من وفرة الدراسات والمقاربات التي حاولت تشخيص الإختلالات التي تعتري النموذج التنموي الحالي، إلا أنها لا تقف بالتحليل العميق عند أكبر خطأ تقع فيه النخب الفكرية والسياسية عندما تعتقد بأن التنمية تخضع لشروط اتباع نموذج محدد تاريخيا أو نظريا. وتحصرها في الأبعاد التقنوية الجوفاء، وتبعد الإنسان كفاعل محوري ورئيسي في التنمية. إن تصور النموذج التنموي كما لو كان حلا سحريا وحيدا للتخلص من “التخلف” بشكل متعالي عن السياقات التاريخية والثقافية للمجتمع، هو مصدر الأعطاب التنموية المتلاحقة. وفي المقابل فإن أي مشروع أو نموذج تنموي لا يمكن تصوره إلا كبناء وتركيب ثقافي في وضعية اجتماعية وتاريخية بعينها، وفي علاقة مع هشاشة بيئة محددة. ولن ينجح أي نموذج تنموي يعتمد أسلوب الاستنساخ الفج لنماذج انبثقت في سياقات مغايرة. وهنا لا بد من التذكير بأن جوهر الهوس لدى الغرب منذ بداية القرن العشرين، هو جعل استنساخ التجربة الغربية طريقا وحيدا نحو التقدم والتطور والتنمية، رغم أن مخرجات هذه المشاريع والتجارب في الغرب هي مخرجات فاشلة مأساوية، وهي مصدر الفوارق والمآسي الاجتماعية حسب وجهة نظر عدد كبير من علماء الاجتماع الغربيين الذين تعتبر أعمالهم بمثابة محاكمة للعقل الغربي. إن هذه النزعة المعولِمة التي تسعى إلى تجاوز الدولة الوطنية باسم الانخراط في العولمة الاقتصادية، هي برأي السوسيولوجي الفرنسي ألان تورين السبب الرئيسي للإحباط الذي أصاب الوعي الوطني وحوله في عدد من المناطق إلى نوع من السادية العدائية، ولا يمكن حسب رأيه، أن تستمر الدول الغربية في إنكار أهمية الدول الوطنية وضرورتها في النمط الجديد من المجتمعات المعولمة، لأن هذا الإنكار محفوف بالمخاطر ومنذر بالمآسي.
إن الغاية من هذا النقد الموجه لمحاولات استنساخ نماذج تنموية انبثقت في بيئات اجتماعية وتاريخية مغايرة لبلدنا، هي التأكيد على أن الخطوة الأولى في بناء أي نموذج تنموي تقوم على معرفة دقيقة بالبيئة الاجتماعية المُفكر لها، وعلى فهم طبيعة المجتمع الذي نسعى لبناء نموذج خاص به. وإذا أردنا أن نقدم تصورا عن طبيعة المجتمع المغربي، فأننا سنعتبره -بلغة بول باسكون- مجتمعا مركبا يصعب تصنيفه في إطار نموذج اقتصادي واجتماعي محدد، أي أنه لا ينتمي إلى أي صنف من المجتمعات بصفة أصلية. صحيح أن المجتمعات الفعلية كلها مجتمعات مركبة، لكنها تنتمي إلى أنواع محددة من المجتمعات حسب توافقها النسبي مع النموذج-المثال. بينما في المغرب نجد تعايشا بين عدد من المظاهر التقليدية والعصرية على المستويات القانونية والفكرية والعائلية، حيث تتواجد جنبا إلى جنب الأشياء الثمينة والأشياء المنحطة. وهذا ما ينعكس حتى على سيكولوجية إنسان المجتمع المركب، الذي يجد نفسه مرغما على تحقيق التوازن داخل شخصيته وعلى إحداث توافق بين كافة هذه الأشكال الاجتماعية المتنافسة.
عندما نصف مجتمعا ما بأنه مجتمع مركب فهذا مدخل لفهم عجزه عن بلورة نموذج تنموي، لأن المجتمعات المركبة حسب باسكون تتجنب تحديد ماهية المشروع المجتمعي الذي يفترض أن يشكل الحد الأدنى من الإجماع العام وأن يكون سبيلا للقضاء على حالة التبعية. إنه مجتمع يحدث النمو الاقتصادي بدون إطار عام وبدون إستراتيجية. ولعل هذا ما يخلق الفجوات المتزايدة اليوم بين الوثيرتين الاقتصادية والاجتماعية، أي بين إنتاج الثروة وتوزيعها. وهو الأمر الذي يختلف تماما عما يحدث في مجتمع الانتقال الذي يؤسس مشروعه المجتمعي على خلق القطيعة مع الماضي والدخول في مسلسل تحريري يتم فيه التخلص من كل أشكال التبعية. إن مجتمعات الانتقال كما وصفها باسكون هي مجتمعات تبحث طواعية عن تصفية الماضي والعلاقات الاجتماعية القديمة وأنماط الإنتاج السابقة بهدف تحقيق النموذج التنموي المنشود. بينما يظل اقتصاد المجتمع المركب يعمل لفائدة نسق آخر يسلبه فائض القيمة.
في ظل واقع اجتماعي مركب يفتقد القدرة على خلق القطيعة مع الأنماط السائدة نتيجة العجز عن تصفية الماضي، سيبقى الحديث عن النموذج التنموي مجرد إنتاج دائم للشعارات التي تقدم نفسها كحلول سحرية يتم التبشير بها، لكنها سرعان ما تتبخر على أرض الواقع. ولا سبيل لتجاوز هذا المأزق إلا إذا تحملت النخب الفكرية مسؤوليتها في صناعة الأفكار الحقيقية، عوض اكتفائها بالمجاملات الصالونية التي تتحاشى الخوض في القضايا الهامة. وأيضا إلا إذا تحملت النخب السياسية مسؤوليتها في الخروج من بطن التاريخ، وتوقفت عن لعبة التوازنات العقيمة التي تنتهي بموت السياسة في نهاية كل مرحلة انفتاح مؤقت.
في الختام، إذا أردنا أن نتحدث عن شيء يدعى النموذج التنموي باختصار شديد يمكن القول إنه لا نموذج تنموي في ظل استمرار استهداف الطبقة الوسطى ومنعها من التشكل والتموقع الطبيعي داخل المجتمع، وفي ظل استهداف المدرسة العمومية وتعميق مشاكلها وأعطابها بإصلاحات تفسد أكثر مما تصلح، وفي غياب مناخ ثقافي مشجع على انبثاق حياة عمومية تحتضن النقاشات التي تؤرق المغاربة، حياة عمومية تضعهم باستمرار وجها لوجه مع القضايا الحقيقية التي ينبغي طرحها دون تغليفها بالشعارات المزيفة، ولا نموذج تنموي كذلك في ظل استمرار إفراغ المؤسسات التشريعية والدستورية من محتواها مقابل خلق تضخم خطابي خارجها، وأخيرا في غياب تملك فعلي لمشروع مجتمعي يحقق الحد الأدنى من الإجماع ويسمح بتملك مستقبلنا المشترك، وطالما أننا لا نتملك مشروعا مجتمعيا له مصداقية، فأننا سنظل نرمق ونلفق ونستعير مخططات ونظريات غير متماسكة نضفي عليها الطابع السحري العابر.