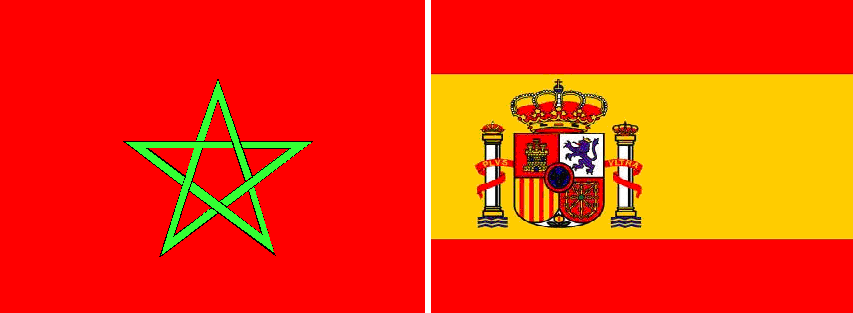اللاقضية

هوية بريس – جمال الهاشمي
بتنا نعيش مؤخرا منعطفا تاريخيا وحضاريا خطيرا للغاية، يتعلق الأمر بتجريد الناس في العالم العربي والإسلامي، وإلى حدود ما في كل العالم غير أن ما يهمنا هنا هو العالم العربي بالخصوص، يراد إذن تجريد الناس حتى من القضية التي يمكن أن يعيشوا من أجلها، فإذا تجرد الشعب من قضاياه العادلة وتبين أنها كانت وهما، ولا داعي إذن أن يعيش من أجل قضية أو يربي أبنائه عليها فهذا أمر بالغ الخطورة، كما لو أنك تُفرغ الشعب والمجتمع من روحه، ثم تدعه كالأنعام لا يهتم إلا بالأكل والشرب وبعض المتع الأخرى حسب ما يسمح به وضعه الطبقي في المجتمع، فالطبقة الكادحة والفقيرة تظل تصارع الحياة كي توفر الفتات وتظل نلهث وراء لقمة العيش إلى أن تُقبر. وكذلك الطبقة المتوسطة التي تظل تلهث كآلة أو كحمار الطاحونة حيث تبقى على دورانها اليوم بأكمله، ثم الأسبوع والشهر والسنة، ثم العمر الذي يدور ويدور حول هدف غريزي في الأصل لا يستهدف إلا البقاء والكفاف، أو كما نقول أن يحقق التعادل مع ضغط المنظومة الاستهلاكية التي تزداد صعوبة في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة التي باتت تمليها الرأسمالية الجشعة.
وحتى في طبقة الميسورين فإنهم يُجبرون ربما أكثر من غيرهم على الانغماس في الاستهلاك النهم من إشباع البطون والاغتراف من ملذات الحياة دون أدنى حس لقضية أو مبدأ، بل تجدهم مرغمون أو متواطئون مع الأنظمة الفاسدة المغيبة لوعي الشعوب للحفاظ على مصالحهم وثرواتهم.
وهذا لعمري إيذان بخراب المجتمع بكافة طبقاته، عندما ينزل إلى درجة الحيوانية والغريزية دون أي قضية يعيش من أجلها ليكافح ويناضل ويبرر وجدوده. هذا الأمر يصدق علينا منذ فصل الثورات العربية ومصادرتها، مع ثروات الشعوب، من مُرتزقي الثورات المضادة بمختلف مهماتهم القذرة، من التخطيط إلى التحريض إلى العمالة والتنفيذ.
فمع نكوص المد الثوري الشعبي وإفراغه من كل معانيه عن طريق التخوين والحبس أو القتل، أو بطريق الاستدراج والتشجيع على الردة الثورية خشية البطش، أو عن طريق النفي والمتابعة والتشويه، تمكنت الأنظمة القمعية من وأد حلم الشعوب في التحرر والعيش الحر الكريم.
هكذا إذن يتم إفراغ المجتمع من محتواه وروحه التي ليست شيئا آخر غير العيش على التشبث بقضاياه العادلة ولو بشكل رمزي. بهذا الصدد أذكر وأنا من جيل الثمانينات وقد يتقاسم معي ذلك من هم من أجيال السبعينات وإلى غاية أوائل التسعينات، أذكر أننا عشنا مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب الأول على إيقاع قضايا وطنية بصبغة دينية واضحة وقد تصطبغ كذلك بالقومية والثورية، فكان كل منا يتفاعل مع تلك القضايا بطريقته، عن طريق الأدب والإبداع الفني مثلا، فالشاعر يُشعر والقاص يكتب والفنان ينشد ويغني للقضية، وساحات الجامعات كانت دائمة الحراك من أجل القضية الفلسطينية كأم القضايا. كان هذا الوعي يمتد للشارع بشكل تلقائي، لا أحد كان يختلف على عداوة المغتصب الصهيوني.
فكل فعاليات الشعب من الجمعيات، النقابات، الأحزاب ومختلف التنظيمات كانت تتفق مع القضية، والمجتمع ككل متشبع بتلك الروح. صحيح أنه لم يتحقق شيء يُحفل به من وراء هاته الأشكال، ذلك أن الأنظمة طالما كانت مُمانِعة لمواجهة حقيقية مع العدو، ولكن الروح كانت هنا ومعها الأمل الذي يعيش عليه الجميع ويورثه الناس لأبنائهم. وهذا أمر بالغ الأهمية وإن بدا شكليا فقطـ، فهذا ما يُبقي جذوة القضية متقدة إلى أن يأتي من يكون أهلا لها، ولكن أن تُنزع الروح وتُطفئ الجذوة فهذا الخطر بعينه، وهو ما نعيشه على أيامنا.
فالقضية الفلسطينية كانت شعار كل الأحرار حول العالم، قضية إنسانية عالمية. وعلى كل حال مثل هذه القضية كانت لها قداستها حتى في الإعلام الرسمي للأنظمة المستبدة، أنظمة لا نشك في استبدادها وظلمها ولكن كانت على الأقل تُبقي مثل هذه القضايا حية في وجدان الشعوب، نعم كان ذلك لمصلحة آنية ولكن تَوافق ذلك مع متطلبات القضايا العادلة للأمة، بما يدع جذوة القضية متقدة وبما يستجيب ولو بشكل رمزي لنبض الشارع فيعبر على الأقل عن مواقفه بشكل أكثر حرية وانطلاق.
هكذا فإن الرعيل الأول من المستبدين العرب لم يجرؤا على الجهر بمملاءتهم لليهود والعمل على استفزاز الشعور الوطني للشعوب، مثلما يحدث في يومنا هذا بعدما أصبحت كل أشكال العلاقات مكشوفة مع العدو الصهيوني متجسدا في الكيان الإسرائيلي. اليوم بات هؤلاء المستبدون الجدد، الذي ساهموا في إخماد الثورات الشعبية وإحالة الربيع العربي إلى خريف بئيس، باتوا يشرعنون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بدعوى المصالح الوطنية والاقتصادية، وبشكل فج وسمج. أما الأدهى والأمر أن فئات، ليست واسعة من الشعب، من المطبلين والوصوليين المحسوبين على الشعوب باتوا يهللون للتطبيع في محاولة لإضفاء الشرعية الشعبية على المواقف الرسمية وأنّا لهم ذلك.
ولكن هذه الخطوة لا تخلو من خطورة، ففي ظل انتكاس الثورات وتوالي الأزمات الاقتصادية والانسداد السياسي في عدد من الدول العربية، مع ما يصحب ذلك من انكفاء الشعوب وقهرها، وبالتالي انشغالها بلقمة العيش والصراع مع الظروف الاجتماعية المزرية، وفي أثناء انشغال الشعوب الحرة المغلوبة على أمرها بواقعها المرير، تتصدر المشهد شرذمة قليلون من الطبقات المترفة والمستلبة وربما المأجورة في بعض دول الخليج مثلا، فيظهرون ما يفهم أنه تماه شعبي اجتماعي ثقافي مع الدولة والمجتمع المزعوم في إسرائيل، وذلك عن طريق تبادل الزيارات مع الصهاينة وإظهار التواصل الثقافي وتبسيطه باعتباره تواصلا أخويا إنسانيا. والحال أن التواصل مع اليهود بل والتعايش معهم وحمايتهم كان ديدن المجتمع الإسلامي والعربي في كل أنحاء المعمور، والتاريخ يشهد أن اليهود عاشوا أزهى فترات تاريخهم في ظل مجتمعات إسلامية، ولكن الأمر هنا يختلف فاليهود المتواجدون بفلسطين اليوم هم صهاينة مغتصبون، محتلون وجرائمهم أكبر ممن أن يواريها تطبيع بليد. والسؤال هنا في ظل هذا التخبط والتعتيم وإفراغ القضية العادلة من محتواها، هو ماذا سنُربي عليه أولادنا؟
كيف إذن يتم التمهيد لتربية الأجيال المستقبلية على اللاقضية؟ لقد تم ذلك عن طريق عنيف أولا بالانقلاب على الخيارات الثورية الشعبية، ثم بعد ذلك عن طريق محاصرة وسجن ونفي وتصفية كل الرموز السياسية، الفكرية والعلمية المعارضة التي يمكن أن تبث وعيا صحيحا عند الناس، ثم بعد ذلك خلق الأزمة الاقتصادية والمالية في مقابل دعم اقتصاد الريع ومظاهر التقدم الإسمنتي الفارغ من أي محتوى إنساني، ثم يأتي الإعلام ليدجن العقول ويصادر الحريات ويحارب باللسان من لم تطلهم يد الأمن، بُغية خلق جيل خائف دوما، ضحل الثقافة، مائع الذوق الفني، منعدم الخيار السياسي، مطحون اقتصاديا أو مرفه ومُباع الذمة.
كانت تلك إذن استراتيجيه خلق اللاقضية في المجتمع العربي، عن طريق ركائز ثلاثة: القبضة الأمنية بمسوغ بُعبع الإرهاب وضمان الأمن القومي، زعزعة الأمن الغذائي عن طريق تأزيم الاقتصاد ومراكمة الدين الخارجي، ثم غرس وتكريس التيه الهوياتي عن طريق آلة إعلامية رسمية جبارة تروج لأفكار تجرم الحرية والإبداع، تتهم المقاومة والتحرر، وتقلب كل الحقائق، فاسحة المجال للرويبضات وكل ما هو تافه وقبيح.
لتكون اللاقضية هي إذن شعار هذه المرحلة، من أجل إفراغ الشعوب من معناها وروحها، وتركها كالهوام سعا وراء الكلأ، وقد نجحوا إلى حد كبير في تهجين هذا الجيل وشغله ببطنه، وإذا ما تم الإجهاز على هوية هذا الجيل ووعيه الحضاري، وهو الذي عايش عصر الثورة ومحاولة الانعتاق، فلا شك أن الأجيال اللاحقة التي ستصير منقطعة عن أي معنى للحرية الحقة والروح الثورية ومعاني تحرر الشعوب والتضحية من اجل قضاياها العادلة، أو على الأقل الثبات على موقف عادل وإنساني إزاءها وتربية الناشئة عليه. تلك الأجيال سوف تنسى أي قضية خاصة في ظل الاستلاب التكنولوجي المتزايد المنبط للثقافة والوعي آخذا الشخص إلى عوالم افتراضية لا أثر فيها للقيم أو الأخلاق وحتى لأبسط معالم للواقع، بل يكاد يندثر فيها الإنسان في مقابل الآلة والهوية الرقمية.
إذن فهذه المرحلة المفصلية الخطرة تعتبر مصيرية، فإذا لم نتدارك الأمر بتوثيق القضايا بمختلف الوسائل، ليس فقط الرقمية منها، إذ أن تربية الأجيال المستقبلية على الحرية والحق والقضايا العادلة التي لا يجب أن تموت، وتلقيحهم بمضادات التهجين الإعلامي والتنميط الثقافي والتمييع الفني والاستلاب الحضاري يعتبر أمرا بالغ الأهمية.
والرسالة أن اللاقضية لا يجب أن نسمح نحن الفئة القليلة الثابتة على الحق بتكريسها وتشبع أبناءنا بها، يجب أن نقاوم من ضمن ما تجب مقاومته ما أسماه الكاتب الكندي آلان دونو نظام التفاهة، إنه نظام متكامل مخطط له لخلق مجتمعات تافهة، ضحلة، بدائية التفكير محدودة المواهب مادية المطالب. ومن نظام التفاهة، إغراق القنوات ببرامج الفن الهابط من مسابقات تكلف الملايين، وبرامج الطبخ والنفخ التي تحول رأس الإنسان إلى طنجرة ضغط، وهذا الخطاب الموجه لتزكية مطالب النفس المادية من شهوات البطن ورغائب النفس المريضة هو ما يزيد من إبعاده عن أي انشغال بالأمور الجادة والقضايا المصيرية.
وذلك في مقابل انعدام أي تكوين جاد يصنع شخصية متوازنة سليمة تناضل من أجل قضية عادلة ما وترثها للأجيال اللاحقة.