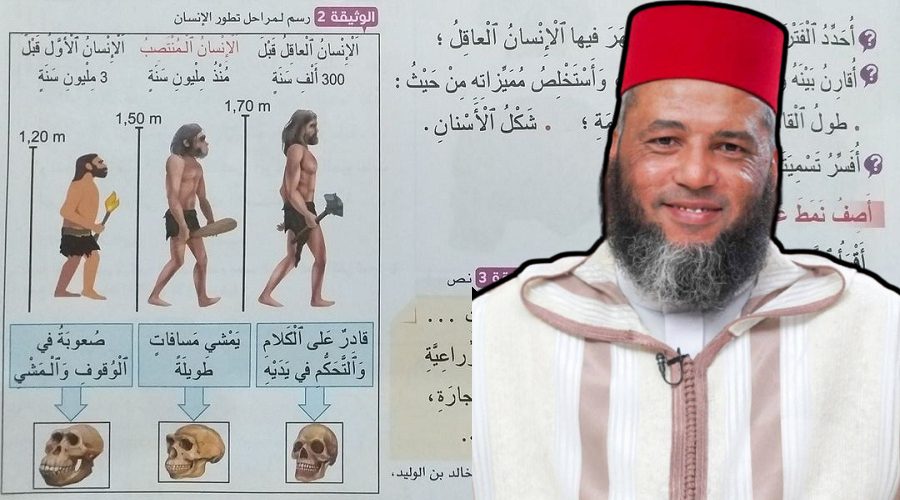الأمازيغية بين الفعل الثقافي الوطني والانزياح الإيديولوجي: نحو تجديد مشروع الهوية المغربية الجامعة

الأمازيغية بين الفعل الثقافي الوطني والانزياح الإيديولوجي: نحو تجديد مشروع الهوية المغربية الجامعة
هوية بريس – د.عبد السلام بامعروف
مدخل: من لحظة الوعي إلى لحظة التوتر
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، ومع صدور ميثاق أكادير (1991) ثم البيان السياسي الأمازيغي (2000)، بدأت تتشكل ملامح وعي جديد بالهوية الوطنية المغربية، يقوم على مبدأ “الوحدة في التنوع” ويعتبر الأمازيغية ركيزة تأسيسية في الذاكرة الجماعية للمغاربة.
هذان النصّان لم يكونا مجرد وثيقتين ثقافيتين، بل كانا مشروعًا وطنيًا للتصحيح التاريخي، يسعى إلى إعادة الاعتبار لعنصر أهمل طويلًا في السياسات العمومية والخيال الجماعي معًا.
لقد جاء ميثاق أكادير في لحظة وعي عميق بضرورة تجاوز الرؤية الأحادية للهوية، وردّ الاعتبار للعمق الأمازيغي باعتباره مكوّنًا من مكونات الذات المغربية، لا مجرد “خصوصية جهوية”. ثم أتى البيان السياسي الأمازيغي ليمنح هذه المطالب بعدًا حقوقيًا وسياسيًا، داعيًا إلى إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة والإعلام، وإلى جعلها لغة وثقافة رسمية تعبّر عن جميع المغاربة.
غير أن الرفض الذي قوبلت به هذه المطالب من قبل بعض التيارات ذات النزعة العروبية أو الإيديولوجية المغلقة خلق ردود فعل داخلية في الجهة المقابلة. ومع مرور الزمن، بدأت تتشكل داخل بعض الأوساط خطابـات أكثر حدة، خرجت عن روح الميثاق والبيان، متبنية منطق “القطيعة” بدل “التكامل”.
من الفعل الثقافي إلى التوظيف الإيديولوجي
ينبغي الاعتراف بأن النضال الأمازيغي الأصيل في المغرب كان في جوهره فعلًا وطنيًا ثقافيًا إصلاحيًا، لا مشروعًا انفصاليًا أو عدائيًا. لقد نادى بالإنصاف والاعتراف والمصالحة الرمزية، لا بالصراع أو الإقصاء.
غير أن التحولات التي عرفها المشهد السياسي المغربي في العقدين الأخيرين – بما فيها خيبة الأمل من بطء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتراجع ثقة الشباب في الأحزاب – فتحت المجال أمام تيارات هامشية تحاول أن تملأ الفراغ بخطاب يقوم على نفي الآخر بدل الحوار معه.
هذه التيارات، وإن كانت لا تمثل جوهر الحركة الأمازيغية، إلا أنها باتت تحاول فرض خطاب إيديولوجي متشدد، يقدم الأمازيغية في مقابل “العروبة”، ويصوّر المكون العربي الإسلامي كعائق أمام نهضة الأمازيغية.
إنها رؤية اختزالية وخطيرة، لأنها تتعامل مع الهوية بمنطق “الصفر الجمعي”؛ أي أن ازدهار مكوّن ما لا يتحقق إلا بزوال الآخر.
لكن الحقيقة أن التاريخ المغربي لا يعرف صراعًا بين الأمازيغية والعربية، بل يعرف تفاعلًا حضاريًا طويلًا بينهما. فالعربية انتشرت في الفضاء الأمازيغي دون أن تُقصي لغته وثقافته، والأمازيغ أنفسهم كانوا حَمَلة اللغة العربية والعلوم الإسلامية في العصور الوسطى، من المرابطين والموحدين إلى فقهاء سوس وفاس.
فمن العبث أن نعيد إنتاج ثنائيات زائفة من قبيل “الأمازيغية ضد العروبة” أو “الهوية المحلية ضد الانتماء الإسلامي”.
جذور النزعة الإقصائية الجديدة
تتغذى هذه النزعات على ثلاثة مصادر رئيسية:
- الردّ العاطفي على الإقصاء التاريخي: فحين يُستمرأ التهميش ويُقابل النضال الثقافي بالتجاهل، يندفع بعض الفاعلين إلى رد فعل مفرط، يساوي بين “المسؤولين عن الإقصاء” و“كل ما هو عربي أو إسلامي”، وهو خطأ في التحليل والموقف معًا.
- تأثير الخطابات العابرة للحدود: بعض المنابر الرقمية الموجهة من الخارج تُغذي خطابًا هوياتيًا متطرفًا، يربط بين الأمازيغية والعَلمنة الجذرية أو العداء للعربية والإسلام، في محاولة لتفكيك الرابط الوطني الجامع.
- ضعف التأطير الفكري داخل الحركة نفسها: فغياب المرجعيات الفكرية الواضحة، وغياب الجيل المؤسس الذي كان أكثر وعيًا بالمشروع الوطني، جعل المجال مفتوحًا أمام أصوات غير مؤهلة لتقود النقاش، فتحولت القضية من مشروع ثقافي جماعي إلى سجال هوياتي ضيق.
الأمازيغية والعربية: تكامل في خدمة الوطن
إن الخطأ الأكبر في الخطابات الإقصائية هو افتراض أن الأمازيغية لا يمكن أن تنجح إلا إذا تراجعت العربية، أو أن تعزيز مكانة العربية يعني بالضرورة تهميش الأمازيغية.
في الواقع، اللغتان متكاملتان وظيفيًا وتاريخيًا. فالعربية شكلت وعاء الدين والعلم والتواصل الحضاري، بينما الأمازيغية حفظت الذاكرة المحلية، والروح الجماعية، وأنماط العيش والتعبير الشعبي. إنهما معًا تعبّران عن “الذات المغربية” في أبعادها المتعددة.
لقد قاوم المغاربة عبر التاريخ جميع محاولات التجزيء الثقافي أو الديني، لأنهم فهموا أن هويتهم ليست قائمة على النقاء الإثني أو اللغوي، بل على الانصهار في مشروع حضاري مشترك. لذلك، فكل من يسعى إلى تقويض هذا الانصهار – تحت أي شعار كان – إنما يعمل ضد المصلحة الوطنية، حتى وإن رفع شعارات الإنصاف.
من الاعتراف إلى التعاقد الوطني الجديد
إن ما نحتاجه اليوم ليس سجالًا حول “من الأحق بالتمثيل الثقافي”، بل تعاقدًا وطنيًا جديدًا يضمن العدالة اللغوية والثقافية دون المساس بوحدة المرجعية الجامعة.
فالأمازيغية، باعتراف الدستور المغربي (2011)، أصبحت لغة رسمية إلى جانب العربية، وهذا الاعتراف لا ينبغي أن يُقرأ كتنازل لأقلية، بل كتحصين لوحدة وطنية تقوم على المساواة في الرمزية والتمثيل.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل هذا الاعتراف في المدرسة والإعلام والإدارة، بعيدًا عن الحسابات السياسوية أو الخطابات المتشنجة. الأمازيغية تحتاج إلى مشروع ثقافي وطني جامع، تشارك فيه كل القوى الديمقراطية والمجتمعية، لا إلى صراع إيديولوجي بين تيارات تتنافس على “احتكار الهوية”.
نحو رؤية جديدة للهوية المغربية
إن الهوية المغربية لا يمكن أن تُفهم إلا باعتبارها هوية تفاعلية، تشكّلت عبر قرون من التبادل بين الأمازيغ والعرب والأندلسيين والأفارقة والمتوسطيين. وهي ليست هوية منغلقة على أصل واحد أو لغة واحدة، بل نظام رمزي مفتوح يتطور مع الزمن.
ولذلك، فإن كل محاولة لعزل الأمازيغية عن بعدها العربي الإسلامي، أو لتصوير العروبة كخطر على الأصالة، هي خيانة لجوهر المشروع الأمازيغي نفسه، الذي وُلد من رحم الوطنية لا من خارجها.
إننا بحاجة إلى أن نُعيد تعريف “الأمازيغية” لا كمجرد لغة، بل كمكوّن ثقافي جامع يعكس التنوع المغربي ويعززه، لا كعنوان للصراع أو الانفصال الرمزي.
خاتمة: الأمازيغية رهان وطني لا ورقة صراع
ختامًا، إننا مع المطالب الأمازيغية المشروعة في إنصاف اللغة والثقافة والتاريخ، ومع حق الأمازيغ في أن يروا أنفسهم ممثلين في الفضاء العمومي، ولكننا في الوقت ذاته نرفض أن تتحول هذه المطالب إلى منصة لإعادة إنتاج الإقصاء الذي حاربته في الأصل.
فمن الخطأ أن نحارب التهميش بتهميش مضاد، أو أن نطالب بالاعتراف من خلال نفي الآخر.
إن قوة المغرب كانت وستبقى في وحدة تنوعه، في تكامل لغاته وثقافاته وروافده الحضارية. الأمازيغية لا تنجح إلا في ظل وطن عربي-إسلامي متفتح ومتوازن، والعربية لا تزدهر إلا في مجتمع يحتفي بأمازيغيته ويفتخر بها.
أما الانغلاق في خطاب “إما نحن أو هم” فهو مجرد تكرار لخطإ تاريخي بثوب جديد.
لهذا، يبقى الأفق الحقيقي هو بناء مشروع وطني جامع، قوامه العدالة الثقافية والمواطنة المتساوية والاعتراف المتبادل، في وطن يتسع للجميع دون استثناء أو إقصاء